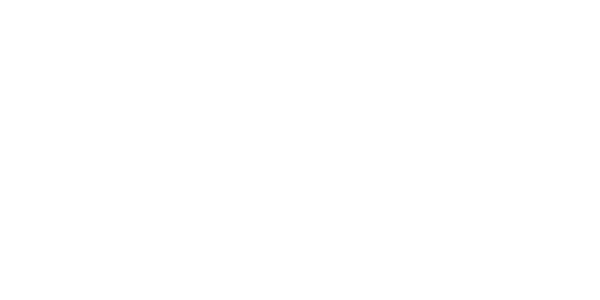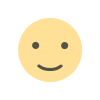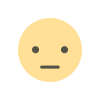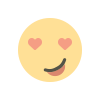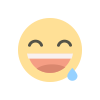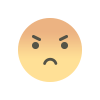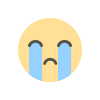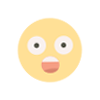البطالة وهجرة العمالة اليمنية

كتبت/ أمل السبلاني
أدّت عقود من الإِضْطراب السياسي في اليمن إلى تقليص النمو الاِقتصادي ومستوى الإنتاج، وقلة العمالة - وخاصة المحترفة - التي اتّسمت بغير الرسمية بنسبة 73.2%، وهيمن عليها الطابع الذكوري. وتركزت أغلب الوظائف في القطاع الزراعي بنسبة 30%، ثم التجاري بنسبة 23%، وما يقرب من 30% من السكان العاملين يعملون لحساب انفسهم.
أثّر الصراع الأخير على القوى العاملة اليمنية، حيث حُرم أكثر من 1.2 مليون عامل في القطاع العام من الدخل، وذلك منذ 2016، إلى جانب الإجراءت التي إتخذتها الشركات الخاصة - التي توقف أكثر من ربعها في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات - حيث قامت بتسريح ما يقدر بنحو 55% من القوى العاملة، وتقليص أوقات العمل.
كما تعطَّل إنتاج النفظ، وتوقف صادِراته، وتضرر كلٌ من القطاع الزراعي، الذي يعمل فيه حوالي ثلث العمالة في اليمن، بعد أن اضطر أكثر المزارعين للتخلي عن أراضيهم، لسوء الأوضاع الأمنية، وارتفاع أسعار الوقود، وازدياد تكلفة الري، ونقص الموارد الأولية لعملية الإنتاج. وتضرر أيضًا قطاع الصيد، وذلك لإرتفاع أسعار الوقود، ونقص برادات التخزين، وإمكانية الوصول المحدودة إلى مناطق الصيد نظرًا لإنعدام الأمن، وإغلاق العديد من مواقع الصيد.
ساهمت جميعها في اِنكماش الإجمالي المحلي، وارتفاع معدل البطالة إلى نحو 60%، في وقت عجز كلٌ من القطاعين العام والخاص من توفير فرص عمل جديدة. ومع ضياع مصادر الدخل، ومواجهة العديد من الصعوبات والتحديات لتوفيرها، أصبح معظم الشباب أمام خيارين؛ أما البطالة، وأما الهجرة والاِغتراب.
برزت ظاهرة هجرة العمالة في اليمن نهاية الحرب الأهلية عام 1970 - وما صاحبها من ارتفاع اسعار البترول - توجهت بصفة أساسية إلى دول الخليج والمملكة العربية السعودية، التي مثلت لها سوق عمل كبير؛ لما تتطلبه من أعداد وافرة للأيدي العاملة - ذات المؤهلات والمهارات البسيطة - ولزيادة الدخل القومي فيها، إلى جانب ذُيُوع النمط الاستهلاكي في اليمن.
تؤدي هجرة العمالة عادة في زيادة الدخل القومي للدولة، ودعم ميزان مدفوعاتها، وتوفير عملتها الصحية، وفي رفع مستوى المعيشة، وتنشيط السوق المحلية، واكتساب المهاجرين للمهارات، والخبرات الفنية، والطاقات، والسلوكيات، والتي ترفع من مستواهم الفكري والسلوكي، إلا أن وضع العمالة اليمنية المهاجرة اختلف تمامًا.
تتّخذ الوجهات التي تركزت فيها هجرة العمالة اليمنية (السعودية، ودول الخليج) - والتي تشكل 80% - إجراءات صارمة تجاه اليمنيين، على خلفية حرب الخليج، واعتبار دول مجلس التعاون الخليجي اليمن تهديدًا ديمغرافيًا لها، حيث قامت السعودية في منتصف التسعينيات بطرد أكثر من مليون مهاجر، والذي سبب أزمة اِقتصادية حادة، وصراعات أهلية وإقليمية؛ نتيجة عودة المهاجرين بشكل مفاجئ، وغياب التخطيط، وضعف البنية التحتية، وتزايد مستوى الفقر، واِنخفاض مستوى العدالة، وعدم تلبية وإشباع الحاجات الأساسية للسكان.
وفي السنوات الأخيرة فرضت السعودية غرامات مالية، وعقوبات بالسجن لمن لا يمتلك وثائق الإقامة من العمالة اليمنيين، ورسوم سنوية مرتفعة مقابل الحفاظ عليها، وتطبق حاليًا سياسة إحلال العمالة السعودية في سوق العمل عن طريق ما سُمي "توطين الوظائف"، وجميعها أنشطة تجبر أعداد كبيرة من العمالة اليمنية لمغادرة السعودية، والذي يشكل كارثة خطيرة لا تقل سوءً عن سابقتها، كون اليمن كان ولا يزال حتى اليوم يعتمد بشكل أساس على التحويلات المالية - إلى جانب المساعدات الإنسانية - التي تشكل نسبة هامة من إجمالي الناتج المحلي GDP، والمورد الرئيس للعملات الأجنبية، ووفقًا لمصادر في البنك المركزي اليمني، بلغ إجمالي التحويلات المالية للمغتربين اليمنيين حوالي 3.8 مليار دولار سنويًا بين عامي 2012 و2015، والذي مثل حوالي 10% من الناتج الإجمالي المحلي، وكان هناك ما يقدر بنحو 6.5% من الأسر اليمنية في عام 2014 تعتمد على التحويلات المالية لتلبية اِحتياجاتها اليومية الأساسية.
وجَّهت منظمة العمل الدولية بنتفيذ مشروع مسح للقوى العاملة في عام 2003، ومنذ ذلك الوقت لم تجرِ أي عملية، الأمر الذي جعل تقييم قضايا سوق العمل، ووضع الهجرة الدولية قضية "إشكالية"، لذلك أطلقت منظمة العمل الدولية واليمن مشروعًا يحسن من إدارة وحوكمة هجرة اليد العاملة، ويبني قدرة إدارة العمال المغتربين على وضع أنظمة جمع البيانات وتحليلها لتحسين صياغة سياسة هجرة اليد العاملة.
وهنا نضع بعضًا من المقترحات، التي من شأنها أن تُحد من هجرة العمالة - والمشاكل المترتبة عليها - وهي خلق فرص عمل من خلال الاستثمار في القطاعات التي تم أهمالها لصالح قطاعي النفظ والغاز، منها الاستثمار في الزراعة، وتطوير صناعة الصيد، وتوسيع عمليات التعدين، وربط جهود إعادة الإعمار بقطاع التشييد المحلي. كما يمكن النظر إلى مبادرات جديدة، مثل بناء منطقة حرة على الحدود اليمنية السعودية، ومن خلال توفير مصادر الدخل هذه على المدى القريب والمتوسط، سوف يساعد صانعو السياسة أيضًا في الحد من عدد اليمنيين الذين يشعرون أنهم مجبرون على الانضمام إلى أطراف مسلحة في النزاع لضرورات مادية.
إضافة إلى ذلك، فإن زيادة التمويل المخصص للتعليم الفني والتدريب المهني الموجه نحو التوظيف سوف يساعد على خلق فرص عمل بشكل ملحوظ، كما أن تخفيض نسبة الفائدة البنكية ضروري، حيث يؤدي ارتفاعها إلى تفضيل أصحاب العمل بوضع نقودهم في البنك دون استثمارها في المشاريع. وأخيرًا، توجيه السفارات اليمنية في الخارج إلى القيام بنشاط دبلوماسي واسع يهدف إلى دعم جهود الجهات الأخرى في تأمين مستقبل الهجرة اليمنية وحاضرها.