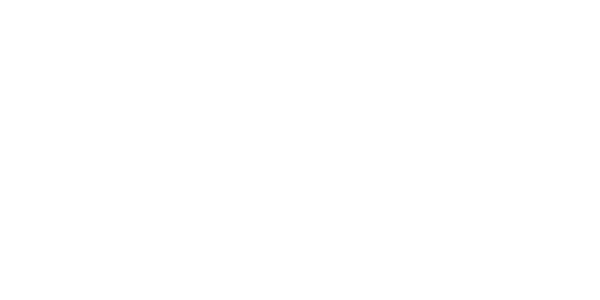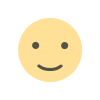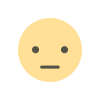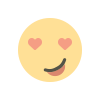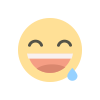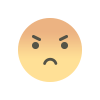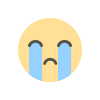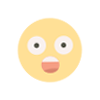الدكتورة هدى علوي لـ "نون وشين" كانت تجربتي في الانخراط المباشر مع المجتمع بكل مكوناته هي اللحظة التي شعرت فيها أن صوتي أحدث فرقًا حقيقيًا

الدكتورة هدى علوي لـ "نون وشين" كانت تجربتي في الانخراط المباشر مع المجتمع بكل مكوناته هي اللحظة التي شعرت فيها أن صوتي أحدث فرقًا حقيقيًا
حوار: لطيفة الظفيري
الدكتورة هدى علوي أستاذة محاضرة في القانون الجنائي بجامعة عدن، وخبيرة استشارية في مجال حل النزاعات، والحساسية للنزاع وبناء السلام. كما تعمل استشارية في قضايا إصلاح التعليم الجامعي، وتمتلك رصيدًا بحثيًا غنيًا يضم عددًا كبيرًا من الدراسات والأوراق العلمية.
حاورتها منصة "نون وشين" واقتربت من رؤيتها العميقة حول القانون كأداة للسلام، وكشفت كيف تحوّلت تجربتها الشخصية إلى مشروع نضالي يتجاوز الحدود التقليدية للعمل الأكاديمي. تؤمن الدكتورة أن السلام لا يُفرض بالقوة، بل يُبنى على الحوار، والعدالة، والاعتراف بالآخر.
دكتورة هدى، ما الذي يعنيه لكِ أن تكوني امرأة يمنية في موقع قيادي وسط مجتمع يمر بتحولات عميقة؟
إن أكون امرأة يمنية في موقع قيادي وسط مجتمع يمر بتحولات عميقة، يعني لي الكثير. فالحضور النسوي كرموز قيادية وعناصر رائدة وفاعلة في مختلف مجالات الحياة، وفي جميع مراحل الصراع والسلام والتحديث والتنمية، يعكس مؤشرًا إيجابيًا على وعي المجتمع، بكل أطيافه النخبوية والعامة، بأهمية تغليب الخطاب الإنساني والحقوقي.
هذا الحضور يعزز مبدأ التماسك المجتمعي، ويدعو إلى تمكين النساء في مواقع صنع القرار كشريكات استراتيجيات، لأننا نؤمن تمامًا بأن إشراكنا في عمليات بناء السلام وصياغة المستقبل يسهم في تكامل الأدوار، وتعزيز مسارات النهوض، وتجاوز التحديات الاقتصادية المتفاقمة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية.
أنا مؤمنة بأن غياب النساء عن المشهد ليس خيارًا، لأنهن صاحبات مصلحة حقيقية في تحقيق الاستقرار. كما أن حضور النساء يسهم في تجنب الكثير من تداعيات الحروب التي تلقي بظلالها الثقيلة.
هل شعرتِ يومًا أن الالتزام الأكاديمي يتعارض مع الالتزام الإنساني؟ وكيف توازنين بينهما؟
بالنسبة لي شخصيًا، تراكمت لدي تجارب إيجابية منذ وقت مبكر في حياتي العملية، سواء من خلال الأنشطة والبرامج والمبادرات التطوعية، أو على صعيد الإنجازات العلمية والبحثية. أجد أن المواءمة بين الالتزام الأكاديمي والالتزام الإنساني ليست فقط ممكنة، بل هي تعبير حقيقي عن تكامل الشخصية ووحدة الأهداف.
على العكس من التعارض، يمكن لهذه العلاقة أن تُفعل بشكل إيجابي، حيث استطعت أن أربط بين التجربة الميدانية والعمل من خلال البرامج والمشاريع التي تستهدف النساء، وبرامج التدريب والتمكين، إلى جانب دوري كمدافعة وقيادية في حملات المناصرة، والمفاوضات، ووساطة السلام. كل هذه الأدوار نشأت من خلفية ثقافية وأكاديمية متماسكة، تؤكد أن لا تضارب بين الالتزامين، بل تكامل يعزز الفاعلية.
كيف تتعاملين مع التحدي الداخلي بين المثالية المهنية والواقع السياسي والاجتماعي المعقّد؟
في الحقيقة، يلفتني عمق التعبير الذي يتجلى في مصطلح "المثالية المهنية"، كما أسميتها، لما يحمله من دلالات تتجاوز المفهوم التقليدي للعمل. لكن دعيني أنتقل مباشرة إلى تأثير الواقع السياسي والاجتماعي، الذي يزداد تعقيدًا نتيجة غياب رؤية عقلانية عادلة ومنصفة، قادرة على رسم طريق واضح نحو الخلاص من دوامة النزاعات، سواء كانت مسلحة أو خلافات سياسية أو تباينات بين مراكز القوى القديمة والجديدة.
هذا التعقيد يضع الأحلام الكبرى والتطلعات المشروعة في مواجهة مباشرة مع تحديات ومعوقات يصعب تجاوزها. ومع ذلك، أرى أن المثالية المهنية تفرض على كل مواطن، سواء كان باحثًا أو أكاديميًا أو قائدًا مجتمعيًا، أن ينخرط في العمل الإنساني، ويسهم في نشر ثقافة التسامح، ونبذ العنصرية وخطاب الكراهية، وترجيح كفة المرجعيات الإنسانية والدولية.
إن تكامل الأدوار بين الالتزام المهني والواجب الإنساني يمكن أن يصنع فارقًا حقيقيًا، ويحدث "ثغرة من النور" كما يُقال، تفتح المجال للخروج من حالة الجمود السياسي، وتجاوز واقع الأمر المفروض، نحو البحث عن وسائل آمنة ومساحات للتعبير، تضمن ضبط أي تجاوزات أو انتهاكات أو ممارسات إقصائية أو تهميشية.
ما اللحظة التي شعرتِ فيها أن صوتكِ أحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الآخرين؟ هل هناك موقف أو تجربة غيّرت نظرتكِ للعدالة أو للمرأة أو حتى لنفسكِ؟
لطالما سعيت واجتهدت في رسم خارطة طريق واضحة للعمل المهني والاجتماعي، بشكل منهجي يعكس قناعاتي وقيمي. ورغم كل ما حققته من تألق وإبداع في مسيرتي الأكاديمية كباحثة ومحاضِرة، كنت دائمًا أحرص على أن تعكس علاقتي بقاعات المحاضرات ثقافة الحوار والانفتاح، وخلق مساحات للتعبير السلس والمرونة في الطرح، مما عزز من قدراتي القيادية في عملي الإداري، خاصة في دوري كقائدة أكاديمية على مستوى مركز دراسات المرأة في جامعة عريقة كجامعة عدن.
لكن التجربة التي أعتبرها نقطة تحول حقيقية، ومقياسًا للأثر والتعلم، كانت تلك اللحظة التي أدركت فيها أن النجاحات الأكاديمية التقليدية، المتمثلة في الألقاب العلمية وعدد الكتب والأبحاث، أصبحت نمطًا متكررًا لا يعكس بالضرورة عمق التأثير. فقد شعرت بخيبة أمل حين وجدت أن العمل الأكاديمي تحول إلى ممارسة مكتبية ونظرية، تستند إلى مناهج بحث قديمة لم تتأثر بالتحولات المعرفية الحديثة، وهو ما يعود جزئيًا إلى التحديات الاقتصادية التي يعاني منها الأكاديميون، والتي حدّت من قدرتهم على إنتاج إبداع اجتماعي حقيقي.
بالنسبة لي، كانت تجربتي في الانخراط المباشر مع المجتمع بكل مكوناته هي اللحظة التي شعرت فيها أن صوتي أحدث فرقًا حقيقيًا. فقد ساعدني ذلك على إطلاق مهاراتي في خدمة قضايا حقوق الإنسان والمرأة، بعيدًا عن المزايدات أو الخطابات الحقوقية المجردة. كنت دائمًا أحرص على أن أعمل من خلال الناس، لا بمعزل عنهم، وأعتبر أن أدواري المتعددة، رغم بساطتها، كانت حيوية ومؤثرة، وشكلت قيمة مضافة لشخصيتي.
كل ذلك شكّل بالنسبة لي تجربة إيجابية أعتز بها، وأعتمد عليها في تطوير أدوات جديدة، تنبع من إيمان راسخ بأن العمل مع الناس، والانخراط في المجتمع، له انعكاسات جوهرية على توازن الشخصية، وعلى شعورها الحقيقي بالمسؤولية، بما يتجاوز مجرد الاعتزاز بالمكانة العلمية أو الأكاديمية.
كيف أثّرت عليكِ تجربة العمل في بيئات دولية مقارنةً بالواقع المحلي؟ وهل خلقت نوعًا من التناقض أو الإلهام؟
بالنسبة لي، كان الاحتكاك المباشر والحوارات والمشاورات داخل الأوساط المحلية عاملًا مهمًا في تهيئتي لاستقبال نقاشات أكثر عمقًا وتأثيرًا على مستوى الخبرة والمعرفة. فرغم صعوبة العمل في السياق المحلي، وما يرافقه من تحديات ناتجة عن طبيعة المنظومة الثقافية والوعي المجتمعي، إضافة إلى تعقيدات البيئة السياسية والاجتماعية بسبب النزاعات المستمرة، فإن هذه التجربة منحتني قدرة على الفهم والتفاعل مع واقع متشابك.
لكن لا أخفي أن تجربتي في الحوارات الدولية كان لها أثر بالغ على وجداني، وعلى اتساع رؤيتي للأمور. فقد أتيحت لي فرصة التعرف على تجارب سبقتنا، تنطوي على أبعاد فكرية وثقافية وحقوقية ملهمة، نحن بحاجة ماسة للاستفادة منها. هذه الحوارات أسقطت الكثير من التصورات السطحية التي تختزل دور المنظمات الدولية أو الإقليمية في ممارسة الوصاية أو فرض أجندات سياسية ضيقة. لقد قابلت نماذج مختلفة تمامًا، أكثر احتواءً، وأكثر قدرة على إرسال رسائل إيجابية، ودعم حقيقي، ومناصرة صادقة، إلى جانب تقدير عالٍ للنجاحات والأدوار التي نؤديها.
لو أتيح لكِ إعادة صياغة مفهوم "التمكين"، كيف ستعرّفينه بعيدًا عن الخطاب التقليدي؟
التمكين، في جوهره، ليس مجرد شعار أو إجراء رمزي، بل هو عملية متكاملة تهدف إلى ردم الفجوات القائمة عبر توفير الأسباب والعوامل الدافعة نحو التقدم، من خلال خلق بيئة مواتية تضمن الحقوق وتفتح المجال أمام الجميع، لا سيما النساء، للوصول إلى الفرص بشكل عادل ومنصف.
عندما نتحدث عن تمكين النساء، تشير معظم التوصيات العلمية والتقييمات إلى أن قطاعًا واسعًا من النساء في بلادنا لا يزال يعاني من الحرمان، ليس فقط في الوصول إلى مواقع صنع القرار، بل في المشاركة الفعلية والمؤثرة. فغالبًا ما يتم إدراج النساء ضمن محاصصات سياسية بين المكونات والأحزاب، تُشترط فيها العضوية الشكلية في مستويات حكومية أو إدارية، دون النظر إلى التمكين كعملية تنموية تقوم على بناء الذات.
في الواقع، الإفراط في استخدام مصطلح "التمكين" دون مراجعة نقدية قد يؤدي إلى فقدان البوصلة الحقيقية لهذا المفهوم، خاصة حين يُختزل في تعيين النساء في مواقع عليا دون تأسيس قاعدة وطنية متينة لدمجهن في المستويات الأدنى.
التمكين لا يعني فقط منح النساء مناصب قيادية، رغم أن ذلك مطلب مشروع تؤكده التشريعات الدولية والدستور الوطني الذي ينص على تكافؤ الفرص، وإن لم يصرّح صراحة بالمساواة بين الجنسين. بل هو أوسع من ذلك، ويشمل الحقوق العامة كالترشح، والانتخاب، والمشاركة السياسية، وحرية التعبير، وهي حقوق مدنية وسياسية لا تزال مقوضة بفعل السياسات القائمة على التحييد والاستقطاب.
لذلك، فإن إعادة تعريف التمكين يجب أن تنطلق من الإيمان بأن النساء شريكات فاعلات في بناء المجتمع، وأن تمكينهن الحقيقي يبدأ من القاعدة، ويُبنى على أساس الكفاءة، والعدالة، والحق في المشاركة، وليس على التمثيل الرمزي أو المجاملة السياسية.
هل ترين أن القانون قادر وحده على تغيير البنية الذهنية المجتمعية تجاه المرأة، أم أن التغيير يبدأ من الثقافة؟
أنا مؤمنة تمامًا بأن القانون أداة حاسمة لا يمكن التشكيك في أهميتها، فهو يشكّل المدخل الأساسي لأي تغيير ثقافي حقيقي. ورغم أن العديد من المفكرين وعلماء الاجتماع يرون ضرورة التوازن بين الوعي الثقافي والسياسات القانونية، فإن تجربتنا المباشرة مع المجتمع تؤكد أن الثقافة النمطية، التي تشكلت بفعل تداخل الأعراف والعادات والتقاليد مع بعض التفسيرات الدينية، أصبحت حصنًا منيعًا أمام أي مبادرات للتغيير أو حتى التخفيف من وطأة التقاليد البالية التي تقيد أدوار النساء في المجال العام.
غالبًا ما تُبرر هذه القيود باعتبارها جزءًا من "القيم الأصيلة"، وتُصوَّر المرأة ككائن مستضعف يجب حمايته من الأعباء والمسؤوليات، مما يؤدي إلى تضخيم المخاوف من مشاركة النساء في الحياة العامة، بل والتخويف من النماذج النسائية الفاعلة والمؤثرة. وهذه معادلة صعبة، تجعل من القانون أداة ضرورية لتغيير الوعي المجتمعي، خصوصًا في أوساط البسطاء الذين تحكمهم الأعراف أكثر من النصوص.
لذلك، فإن إعادة النظر في المنظومة القانونية، وتحريرها من التفسيرات التمييزية، هو شرط أساسي لأي تحول ثقافي حقيقي. فالمساواة ليست ترفًا، بل قضية استراتيجية للتنمية، وضمان لعدالة شاملة لا تستثني أحدًا.
في ظل النزاعات، كيف يمكن للقانون أن يكون أداة للسلام وليس مجرد وسيلة لضبط الصراع؟
في ظل النزاعات، لا يمكن للقانون أن يكون مجرد وسيلة لضبط الصراع أو تأجيل نتائجه، بل يجب أن يتحول إلى أداة حقيقية لصناعة السلام. فالقانون، إذا لم يُصغ ليعكس تطلعات وأحلام جميع فئات الشعب، باختلاف أعراقهم، مناطقهم، انتماءاتهم السياسية، مستوياتهم الفكرية والمادية، فإنه يفقد قدرته على تحقيق التسوية العادلة، ويصبح مجرد غطاء شكلي يُزيّف الواقع.
لقد أثبت التاريخ أن القانون سلاح ذو حدين؛ يمكن أن يكون أداة للعدالة، كما يمكن أن يُستخدم لتكريس القمع. ومع ذلك، تظل القواعد القانونية هي المحك الأساسي لحماية حقوق الناس، وبدونها لا تستطيع أي سلطة أن تدير الدولة بشكل عادل أو مستقر.
لكي يكون القانون أداة للسلام، يجب أن يتضمن مبادئ المصالحة والعدالة الانتقالية أو التصالحية، لا سيما في المجتمعات التي تعاني من التفكك والصراعات الدموية. فالعدالة التصالحية، في مثل هذه السياقات، قد تكون أكثر أمانًا وواقعية، وتُمهّد لمرحلة جديدة من السلام الأهلي، حيث يُعاد تنظيم الممارسات السياسية ضمن إطار قانوني يكرّس المسؤولية ويضبط التجاوزات.
كيف تتصورين مستقبل المرأة اليمنية في ظل التحولات السياسية والاجتماعية الراهنة؟
من منظور تفاؤلي واستشرافي يغلب عليه الإيمان بأن التغيير هو صناعة إنسانية، أتصور مستقبل المرأة اليمنية في ظل التحولات السياسية والاجتماعية الراهنة كفرصة واعدة، رغم التحديات. فالتراث النسوي في بلادنا مشهود له، وقد عكسته تراكمات الخبرة لدى الحركة النسوية، إلى جانب التطور الملحوظ في مستوى النخب النسائية وقدرتهن على إيصال أصواتهن بثقة وكفاءة عالية في مختلف المواقع.
وفق هذه الرؤية القريبة، تبدو المرأة اليمنية حاضرة بقوة في المشهد السياسي والحقوقي، كما كانت دائمًا بطلة في معارك السلام، سواء داخل المؤسسات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني، أو في الهيئات الإدارية والسلطات المحلية في مختلف المحافظات. لقد آن الأوان لأن تنال المرأة استحقاقاتها، خاصة بعد أن أثبتت التقارير الدولية والمحلية أنه لا توجد مبررات منطقية أو مقنعة تبرر استمرار سياسات الإقصاء والتهميش بحق النساء.
ما هو الحلم الذي لم يتحقق بعد، وترين أنه يستحق أن يُقاتل من أجله؟
الحلم الذي لم يتحقق بعد، والذي أؤمن بأنه يستحق أن أستميت في الدفاع عنه، هو بناء مجتمع آمن وعادل، خالٍ من التطرف، تُصان فيه الحقوق دون الحاجة إلى القتال أو الاحتراب. فأنا مؤمنة تمامًا أن الحقوق، مهما كانت عظيمة، إذا انتُزعت بالقوة وسقط في سبيلها الأبرياء، فإنها تفقد جوهرها الإنساني، وتتحول إلى عبء أخلاقي.
هذا الحلم يتطلب قادة مرحليين شجعان، يمتلكون القوة الأخلاقية والوعي السياسي، ليواجهوا التطرف حتى داخل المؤسسات السياسية والحزبية، وفي الجامعات، وفي فضاءات التعبير والبحث العلمي. فالأفكار الشمولية المتطرفة، التي تضغط على الإنسان في هذا الزمن، نتيجة الخلافات الأيديولوجية والثقافية والسياسية، أعادت إنتاج "الحرب الباردة" بشكل أكثر سخونة، وجعلت الإنسان الحلقة الأضعف في معادلة الصراع.
لذلك، فإن الحلم الذي يستحق أن يُدافع عنه بلا تردد، هو بناء مجتمع يؤمن بالتعدد، ويُكرّس حرية الفكر، ويُحارب التطرف، ويمنح الإنسان حقه الكامل في التعبير والاختيار، دون خوف أو وصاية.